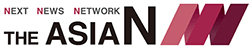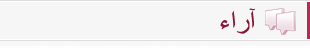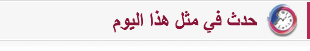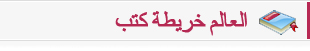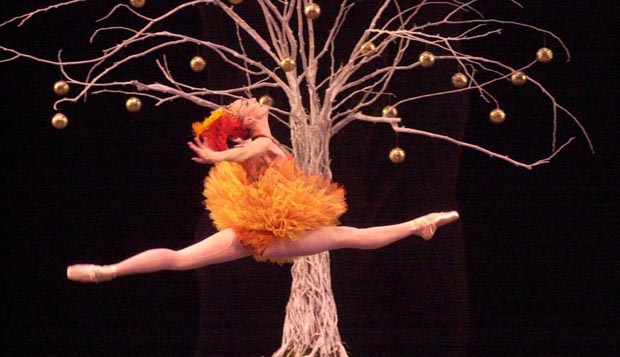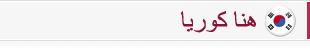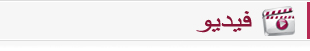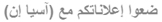??????? ??? ??? ????? | ????? ?????
???? ?????? ????????? ???? ?????? ??? ????? ???? ????????? ???????? ???? ?????? ??. ???? ??? ????? (1956 ? 2016) ????? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?????? ??? ??????? ????? 2020? ????? ?? ????? ????? ?????? ??? ??? ???? ??????? ??????? ???? ???? ????? ???? ????? ????????? ???? ?????? ????? ???????? ?? ???? ???? ?????? ???? ???????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ???? ???????? ???????? ????? ??? ????? ????????? (?????)? ??? ????? ??????? (??????? ??? ??? ????? | ????? ?????)? ????? ?? 13 ???? (17 ? 29)? ????? ???? ????? ?????? ??????? ?? ???????? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ?????? ?????? ????? ?????? (???? ???? ???? ??? ??????) ?????? ?????? ?????? ?????? Hemant Divate? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ??? ?Ko Un? ???? ???? ??????? ?? ?? (??? ???? ?????)? ???? ?? ???? Cho Oh-hyun ???? ????? ?????? (???? ???? ?????)? ?????? (????? ???? ????? ???) ??? ????? ?? ?????? ????? ?Manhae? ??????? ????? ??????? ?????? ????? ??? ?? (???? ??).

????? ??????? ?????? ?? ???? ??????? “???? ???????? ???? ??????” ??? ??? ?????? ??? ?? ???? ????? ????: ?Traduttori traditori “”? ?? “????????? ??????” ??? ?????? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ?????? ???? ????? ???? ??? ????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ?Giuseppe Giusti.
?? ????: ??? ????? ????? ????? ?? ??????? ???? ??? ???? ?? ????????
??????? ?? ?? ?????? ???? ???? ???? ??????? ????????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ?????? ?????????? ????? ???? “??????? ?? ????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ??????. ?? ???????? ??? ??? ????? ????????? ????? ????? ???????? ????? ????????? ?????? ???? ???? ??????: ???????? ????????? ????????.” (1)
???? ????? ?????? – ???? ????? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? – ????? ???????? ????? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ??? ?? ?? ????????? ?????? ???? ???? ?????? ???? ?? ??????? ???????? ??????? ????????? – ???? ????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??.
???? ???? ???? ????? ??? ?????? ?? ????? ?????????? ??? ????????? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ??????? ???????? ????????? ?? ????????? ????? ?? ?? ???????? ????? ??? ????? ????? ???????.
??? ??? ????????? ????????? ??????? ?? ??? ?? ??????? ???? ???????? ???????? ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?????.
????? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ????????? ??? ????? ??????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ???? ????? – ?? ???? – ????? ????????? ??? ???? ?? ??????? ??? ????? ??? ???? ????? ?????? ????? ?????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????? ?? ????? ????????!
??? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ??? ?????????? ?? ?????? ??????? ??????? ??? ?????? ???? ???? ???? ???? – ??? ?? ????? – ?????? ??? ????? ???????? ?? ????? ????????? ??? ?? ????? ????? ?? ?????? ???????? ????????.
??? ????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ???? ??? ??????? ????????? ????? ?????? ???? ?????? ?? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? Wordsworth ???????? Coleridge ??????Eliot ? ????? Auden ? ??? ???? ??????? ????? ?????? ????? ??? ??????? ?????? Shakespeare’s sonnets ??? ???????.
?? ??? ??????? ??? ???????? ??????? ???? ?? ?????? ????? ??? ????? ?????? ???????? ???? ???? ???????? ?????????? ??????? ??? ???? ?????? ????? ???? ????? ???????? ???? ?? ?????? ?? ??? ?????? ????? ???????????? ??? ????? ????? ?????? The Chinese Literature ? ??? ?????? ???? ?????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ???????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ????? ??????? ???????? ????? ????? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ????????? ??? ??? (?????????).
??? ???? ???????? ?? ??????? ????????? ?? ????? ????? ???? ??? 1907? ?? ??? ?????? ???????? ??????????? ???? ??? ??? 1909? ???? ????? ??? ????? ????? ?????? ????????? ?? ???????? ??????????? ?? ??? ??????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ????? ??????? ???????? ?????. ??? ?? ????? ???? ????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??? ???? ??? ???? ??? 1911? ????? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ????? ????????? ??? 1912? ??? ????? ????? ??? ?????? ???????? ??????? ?????????.
???? ??????? ???? ????? ?? ?????? ?????? ?????????:
“??? ????? ?? ????? ???? ???????? ?? ???? ??????? ???? ????? ?????? ???
????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??? ?????? ???? ???? ?????? ????? ????????
??????. ????? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ?? ????? ??? ?????
??????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ?? ??? ????? ?? ???
???? ??? ???? ?????? (????????) ?? ?????. ??? ???? ????? ??? 1912? ???? ????
?????? ?? ??? ????? ??? 1915? ???? ??? ??? 1916. ???? ???? ??? ???? ?????
???????? ???? ?????? ??????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ???????????
???? ?????. ??? ??? ???????? ????? ????????? ???? ??? ????? ?? ???? ???????
??????? ??? ??????? ?????? ????? ???? ??? ????? ???? ????? ??????? ????? ???
?????????? ?????(1861-1941) ??? ???????? ???? ????? ?????? ??????? ???????
???????? ??????? ??????? ???????. ??? ??? ?? ??? 1913 ????? ???? ?????? ?????
??????? ??? ??????? ????????? ????????? ??????? ?? ?? ???????? ??????? ??? ??
?????? ????????? ?????? ????? ?? ???????.
??? ???????? ?? ??? ????? ?? ??????
???? ?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ?????? ???????? ?? ????? ????? ????
??? 1917 ??? ????? “????????”.
??? ??? ???? ???????? ?? ???? “??????” ?? ???? 1916 ???? ?? ????? ????? ????? ?????? ??? ?????? ??????. ???? ???? ???? ?? ????? ????? ????????? ??? ???? ??? ???? ???????? ????? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? “????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ?????? ????? ?????”.
??? ??? ???????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? ????????? ??????? ?? ?????? ???? ???????? ??? ????? ROMESH DUTT ?????????? ???????? ??: RAMAYANA:EPIC OF RAMA,PRINCE OF INDIA ???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ????????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ???????. (2)
?????? ????????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ??? ?????? ???????? ??????? ??? 24 ??? ??? ?? ?????? ????? ?? ???? ?????? ?? 287 ????.
????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?? ??????????:
?????? ???? ??? ????????? ???? | ???????? ????????? ????? ??? ??????
??? ???? ????????? ?? ???? ????? | ??? ??????? ???? ??????? ??? ????
?????? ???? ??????? ??????? ?? ????? ????????? | ??????? ????? ???? ???? ???????
??? ???? ????? ????? ?????? ?????? | ?? ???? ????? ???? ????? ?? ??????
“??? ??????? ??? ??? ??? ??? ??? | ????? ????? ????? ?????
???? ???? ????? ?? ???? ????? | ??? ???? ????? ????? ?????”
?? ??? ?????? ??????? ???? ??? ??? ???????? ??? ????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ?? ???? ???????? ??? ????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ??????? ?? ????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ??????? ??? ??? ?????.
??? ??? ??? ?? ???? ???????? ??? ????? ??????? ????? ???????? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ?????? (???? ???? ???? ??? ??????). (3)

??????? (?? ??????) ?????? ??????? ??? ?? ????? ?? ???? ??????
??? ?? ????? ??? ????? ??????? ???? ??? ??????? ?? ???? “??? ?????” ???? ?????? ????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ?? ????? ?????????? ????? ????? ???????? ????? ???? ????? ?????? ???? ????. ?? ???? ??????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ????? ????????? ?? ???? ???? ?? ????? ??? ??? ????? ???????. ???? ???? ?????????? ?????? ?? ????? ??????? ??? ??? ??????? ???? ????? ?? ???? ?????? ????? ??? ????? ??????? ??????? ?????? ????? ???? ????? ?????? ??????? ??? ????? ???? ????? ???????. ??? ??? ??? ???? ?? ????? ????? ?????? ???? ???????? ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ?? ???? ??????? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????? ?? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ????? ????? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ?????? ???????? ?????? ???????? ????? ???? ?????.
??? ???? ????? ??? ?? ????? ????? ????? ??? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????. ???? ????? ???? ???? ??????? ???????? ???? ????? ?? ???????? ????? ????? ??? ??????. ?? ?? ???? ????? ???? ??? ???????? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??? ????? ?????? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ??? ??????.

????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ??????. ?????????? ???? ???? ????? ?????? ????? ??? ????? ????? ????????? ??? ???? ???? 23 ??? ????? ?? ?????? ?????? ???? ?? 70 ????? ???? ??? ?????? ???? ??????? 19 ?? ????? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ??? ?????? ???? ???????? ??? ?? ????? ????? 900 ????????.
??? ???? ??? ????? ????????? (???????) ???? ??? ??????? (?????)? ??? ???? ????? ?????? ?????? ??????? ??? ?? ????. ?? ????? ????? ????? ?????? ?????? ??? ???? ????? ??? ????????? ??????????? ???????? ????????? ? ????? ?????? ? ?????? ???? ?? ??? ??? ???? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ???????? ?????? ??? ?????? ???? ????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ????????.
????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????? ????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????? ??????? ?? ???? ??????? ???? ????? ?? ???? ?? ?????? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ???????? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ???? ????? ????? ? ??? ???????? ??????? ????? ? ???? ??????? ????????? ???? ?? ????? ??? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???? ???????? ???????.
?? ????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ???? ?? ??? ????????? ??????? ????? ??? ??? 70 ????. ?? ??? ?????? ??????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ??????? ???? ???? ???? ????????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????.
?????? ???? ???? ??? ??? ???? ?????? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ??????:
“???? ???? ????? ???????? ?? ?????
???? ?????? ?? ????
?????? ??????? ???? ??? ?????
??????
??? ??? ???? ???
?????? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ?????? ????????
???? ?????? ??? ?? ????? ?????”
??? ?? ???? ?? ??????? ????????? ?? ??? ???? ???? ????? ?? ????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ???????? ????? ?????? ???????? ???????? ??????SARABJEET GARCHA
??? ???????? ?????? SARABJEET GARCHA ??? ????? ?? ?????? ?? ??? 2004. ???? ???????? ???? ?????? ???????? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ??????????. ??? ??? ????? ?? ?????? ?????? VaaniPhirBhi Shoonyamanaa (??? ??? ????? ??? ????? ????? ?????)? ??? ??? ?? ??? 2011 ?????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ??? ????? ????????? ???????? ????????? ????? (2009) ???? ??? ????? ???? ????? (2011-2012) ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ?????? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ????? ??? ???? ??? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ???????? ???????.
?? ?? ???????? ????? ??? ???? ???? ??????? ?? ????????? ??? ?????????? ????? ?? ????? ?????? ????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ??? ???????:
???? ???? ???? ?? ??????? ???????? ?????????? ????????
??? ?? ?????? ?????? ????????
???? ????? ??? ???? ?? ??? ????? ????
?? ???? ?? ????
????? ??? ?????? ?? ?????
??? ???? ?????? ???????? ????? ?? ????
????? ????? ???????
????? ????? ??????(*)
?????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ???????
????? ???????? ?? ????
??? ????? ?? ????? ???????
??? ????
?????? ?? ?????
??????? ???
???? ?????? ?????(**) ???????(***) ??????(****) ???? ??????? ???
??? ???? ??????? ????????
??? ???? ???? ????? ??????
??? ??? ???????? ????? ??????(*****)
??????? ????? ?? ??????? ??????? ???????
????? ?? ???????? ??????? ???? ??? ????
??? ???? ?????? ?? ?????
?? ??? ????? ??????
???? ?? ???? ????
?? ???? ????????? ??? ?? ??(*******) ???????(*******)
?????? ??? ??? ?????????? ????????
?? ?? ??????? ???? ??????? ????
???? ??? ????????
???? ???? ????? ?? ????? ?????
???? ???? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ??????
_______________________
???? ??????? ???? ?????:
(*) ???? shubham karoti ???????????
(**) ??????-????? shankar-palya ?????? ????? ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ???? shakarpar? ?? ???? ?????. ??? ???? ?????? ????????
(***) ???? chivda ??????? ???????? ?????? ?? ????? ?????
(****) ???? laddu??????? ???? ???? ?????
(*****) ???????? samosa ???? ????? ????? ????? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????? ????? ???????? ??????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????????
(******) ???? kho-kho ?? ???? ????? ????? ?????? ???? ?????? ?? ???? ??? ?????
(*******) ???? kabaddi ?? ???? ????? ??? ?? ???? ????
????? ???????: ???? ?????
?? ??? ????? ??????? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???? ???????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????? ????? ???? ?????? ??? ??? ??? ?? ???? ?????????? ??????? ???????? ??? ??? ??????? ??????? ???? ???? ????? ???? ???????? ??? ???? ??? ??? ????? ?? ?????????? ??? ??? ????? ?? ????? ??????? ???????? ???? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ?????????
???? ????:
“?? ???? ?? ???? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ???? ?? ?????? ????? ??
??? ????? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ??? ???? ?????? ?????? ???????? ??
????? ????? ??????. ??? ??? ??? ????? ???? ??? ??? ???? ????
???? ?? ??? ????? ?????? ??????? ??? ???????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ?????
??????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ?? ?????. ?????? ??? ???? ?????? ??????
?????? ?????? ???? ???????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ??? ??? ???? ???? ?????
????? ????????? ????? ?? ???? ??????: “??? ????? ?????? ??????
??????”! ????? ??????: “?? ??? ??? ???? ??????? ????? ??? ??????”. ???? ??? ??????? ???? ?????? ????? ?????????? ??? ?????? ??????
??????? ????????? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ????? ????
???? ?? ??? ??????? ????? ??????.
???? ??????? ???? ???? ??? ?????
(????? ???? ?? ?????)? ??? ?? ???? ????????? ????? ?? ??? ????? ???? ????? ??
??????????? ???? ??? ?? ??? ????????? ????? ?? ???? ????? ???? ????? ?? ?????
????????? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ???? ??????? ??????.. ??? ??
????? ???? ?????? ?? ????? ??? ?? ???????? ??? “???? ??? ?? ??????”
?????? ?? ????????? ?????? ???? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ???? ????
???? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ???? ??????. ?????? ????
??? ?? ????? ????? ??????? ?????? “??? ???????” ???? ????? ?????? ??
?????????? ??????? ??? ??? ????? ????????? ???? ??????? ?? ????? ?????.”(4)
??? ???? ?? ???? ?????? ?? ????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ???????? ???? ???? ???? ????? ??????? ??????? ???? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ???? ??????? ????? ?????? – ??????? ?????? ????????? (????? ?? ???? 1960) ?????? ?????????? ??????? (??? ??? ???) ????? ??????? ????????? ??? ????? ?????? ???? “??????? ???????” ??????? ????? ?????.? ?? ? ????? ?????? ???? ??? ?????. ??? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ????? ??? 1991 ?? ????? “???????” ?????? ?? “?????? ?????????”? ??? “??? ?????????? ?? ???? ????? ??????? ?? ???. ?????? ?????? ?????? ????? ???? ??????. ?? ???? ?? ????? ?? ????? ??????? ????????. ????? ?????? ??? ????? ????? ????????? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ?????? ??????. ?? ??? ?????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ???????. ???? ????? ?????? ?? ????? ????? ????? “?????? ?? ??? ???????” ??? “???? ????? ?????”? ??????? ??????? ??????.
????? ????: “??? ???? ??????? ???????? ?? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ??????? ??????? ???????? ????? ?? ????????? ????? ?????? ?? ????? ????? ????? ? “??????” ????? ?? ????? ???? ????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ????? ???? ???? ??????. ???? ???? ?? ??? ????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ???????? ??????? ?? ???? ???????.” (5)
??? ?? ?????? ???? ???? ??? ??????? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ??? ??? ??????? ??? ???? ??? ????? ??????? ??????? ???? ???? ???????? ???? ??????? ??????? ????? ???? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ???? ????? ??????? ??????? ??? ??? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ????? ??????? ????? ?????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ?? ??????? ????????? ?? ??? Ko Un? ???? ???? ??????? ?? ?? (??? ???? ?????)? ???? ?? ???? Cho Oh-hyun ???? ????? ?????? (???? ???? ?????)? ?????? ????? Manhae? ???? ??? ?? ????? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ??????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??????? ????? ??? ???.

- ????? ??????? ?? ??? (??? ???? ?????)
?? ?????? ????? ?????? ???????? ??? ?????? ?????? “?? ???”. ???? ???? ????? ???????? ??? ?? ???????? ???? ???? ???????? ?? ??????? ????? ?????? ??????? ????????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????????? ???????? ????? ??????? ????? ???? ?? ???? ????? ?????? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ??? ????? ?? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ???????? ???? ?? ???? ????? “?? ???”. ??? ??? ?????? ???? ?? ??? ???.
???? ??? ????? ???????? ??? ??????? ?????? ?? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???? ??? ????? ????? ???? ????? ????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ??????????? ???? ????? ???? ??????? ??????? ???????. ??? ?????? ?????? ???? ?? ??? ??????? ??? ????? ?? ???? ?????? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ?? ?????? ???????? ???? ???? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ????????? ???????. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ????? ???????? ???? ???? ????? ??? ??? ????????? ????? ???.
??? ?? ????? ???? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ???? ??? ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ?????? ??????? ?????????. ??? ??? ???? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ??????????! ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ? ???? ??? ? ????? ???? ?? ?? ??? ??????? ???????? ??? ??? ??????? ??? ?? ????? ???????. ??? ??? “?? ???” ??? ??? ?????? ??????? ?? ???? ??????? ???? ????????? ??? ?? ???? ????????? ?????????.
???? ??? ????? ????? “?? ???” ?????? ????? ???? ????? ?????? ??????? ??? ????? ???????? ?????? ????? ???????? ???? ????? ?? ???? ??? ?????? ?? ???????? (??????????) ???? ?????? ??? ?????? ?????? ??????. ???????? ???????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ??? ?? ???????? ??????? ???? ?? ??????? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ??????? ??? ???? ???? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ???? ????? ???? ?? ??????.
??? “?? ???” ??? 1933 ?? ??????? ??????? ????? ????????? ?????? ?? ????????? ??? ???? ????? ????? ???????? ???? ?? ????????? ?? ???? ????????? ??? ???? ????? ?????? ??????? ?? ????? ????. ??? “?? ???” ??? ?????? ??? 1958? ?????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ?????? ????? ??? ???? ??? 1960 ????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ???????????? ?? ?????????? ????????????? ??? ???? ????? ?? ????? ????? ??????.
??? “?? ???” ???? ?? 150 ??????? ????? ?????? ??????? ??????? ????? ????????? ?????? ???????? ???????? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ??????? ?? ??? ?????? ????? ??? ????? ???????. ??? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? 14 ???? ??? ????? ????? ????????? ???????? ?? ????? ??? ??????. ??? ??? “?? ???” ?????? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ????? ? ????? ?? ???? ????? .
??? “?? ???” ?????? ?? ????? ?????? ???????? ??????. ??????? ?????? ???? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ?? ??? “?? ???” ?????? ?????? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ?????? ??????.
??? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ?????? “?? ???” ??????? ??? ????? (????) ???? ??? ??????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ??????? ??? ????? ????? ????? ?? ???????? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ??????? ???? ??? ???? ?????.
??? ??? ???? “?? ???” ????? ?????? ?? ?????? ? ????? ?????? ???? ??????? ???? ??? “?? ???” ????? ?? 7 ??????? ?????? ?????? ????????? ?? ???????. ???? ??? ?????? ?? ??? ??????? ???? ?? ?????? ????????? ??? ????? ?? ?????? ???? ????? ???????? ?? ?????????? ????????????.
??? ???? ??? ????? “?? ???” ???? ?? ?????? ????? ??????????? ??????? ????? ????? ???? ??? ?????? ???????. ??? ??? ??????? ???????? ????? ????? ???? ????? ??????? ? ?? ?????? ?????? ?? ???????. ? ??? ??? ???? ?? ???? ??????? ??????? ???? ??? ??????. ??? ???? “?? ???” ??? ?? ????? ????? ???? ????? ??? ??? ??? ??????? ???????? ??? 1970? ??? ???? ?????? ????????? ?? ??????? ?? 1972. ???? ??? ?? ??????? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? 1980.
????? “?? ???” ?? ??? ?????? ???????? ???????????? ???? ???????????? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ? ?? ??? ??????? ? ??? 1982 ?? ???? ? ?? ??? ?????? ????? ?????????? ?????? ??? ?????? ????? ????? ???? ?????. ???? ????? ????? ???????? ??? ??? ????? ???? ??? ??????? ?? ?? ??? ?????? ??? ????? ?? ???? ????? ??????? ???????? ??? ??????? ?? ????? ????? ??????. ??? ???? ?? ???? ????? ??? ????? “???????? ??????”? ??? ????? ??? ?????? ???? ???????? ???????? ???? ???? ???? “??? ???”? ???? ????? ????? ???? ?? ??? ??????? ???? ?? ????? ?? ????????? ?? ???????? ???????.
????? “?? ???” ????? ?????? ???? ????? ??????? ?????? ???????? ??????? ???????? ?? ????? ???? ? ?? ? ??????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ???????? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ???????.
???? “?? ???”? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ???? ????????? ???????:
“?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ????? ???? ??????? ?? ????? ???? ?????. ?? ???? ????? ????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ????? ?????. ????? ?? ??? ???? ????????? ??? ???? ??? ??? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ????? ??????? ????? ??????. ?? ????? ??? ???????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????. ????? ??????? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ??????? ?????? ?? ???? ??????”.
???? ???? “?? ???” ??????? ?????? ???????? ?? ?? ????. ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ?????? ?? ???? ??????? ?? ????? ????? ???? ? ????? ?? ?? ?? ???? ? ??? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ?? ?????. ??? ??????? ???? ?????? ??? ????? ???????? ?? ???? ??????? ??? ?????? “?? ???”. ???? ??????? ? ??????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ?????? ? ?? ???? ??????? ????? ????????? ?????: “??? ???? ?????”? ????? ??????? ?????????? ??????? ????? ?? ????????? ????? ?????? ?? ????? ??????? ??????. ??? ???? ???? ??????? ??????? ??????? ?? ????? ???????? ????????? ???????? ???? ???? ?????? ????? ??? “?? ???”. ??? ?? ?????? ???? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ???????. ??????: “?????? ?????? ??????? ??!” ???? ??? ?? ?????????? ??? ??????. ???? ??? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ??? ?? ???? ??? ?? ??????. ?????? ??? ??? ????? ????? ??? ?????.
??? ???????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ?? “?? ???”? ????? ???? ???? ?? ??? ????????? ????? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ??????? ?????? ?? ????? ???????. ??? ?????? ??? ??? ??????? ??? ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ?????? ??? ???????? ??????? ??????? ??? ???? ??? ???????? ???????? ??????. ????? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ????? ????????. ???? ?? ??? ??????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ??? ??? ??????? ????? ????? ??? ????? ???? ????? “?? ???” ???????.
???? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? (?????) ?? ????? ???????? ?? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ?????????????????? “???? ?????”? ?????? “?? ???” ???????? ?????? ??? ????. ???? ?????? ??? ??????? ????? ???? ?????? “?? ???” ???? ????? ?? ????.
????? ?????? ??????? (?????? ??????) (6)
???? ???? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ??????.
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????? ???????? ???? ??? ????? ??? “??????” ???????? ?? “??? ?????”? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ?? ??? ????????.
???? ??????? ???????!
?? ????? ??? ??? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ???????
??? ????? ?????? ???? ??? ??? ?????? ???? ???? ???? ????? ?????? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ??? ?????????. ??? ????????? ?????????? ??? ???? ????? ???????? ??? ??? ????? ??????? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ??? ?????? ???? ?? ????? ???? ??? ?????.
????? ?? ??????? ??????? ??? ??????.
???? ??? ???? ?????? ?????? “?? ?? ????????” ???? ??? ??? ?????? ? ???? ?????? ?????????? ???? ????? ???? ? ?? ???? ??? ?????? “?? ?? ????????” ????? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ???.
??? ???? ??? ??? ???? ???? ???? “??????????” ????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ????? ????? ?????. ??? ?? ??????? ?? ???? ???????. ???? ??? ??? ?? ????? ??????? ??? ????? ??? ???? ?? ???????? ?? ??? ?????? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ?????. ????? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ??????? ????? ??? ??? ????? ???? ??? ??? ????? ???? ????????? ??? ???.
??? ??? ?????? ???? ??? ??? ????? ??? ?????? ?? ???? ?????. ????????? ??????? ????? ???? ???? ?? ????? ??????? ??? ?????? ??????????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ?????. ???? ?????? ??? ????? ????? ???????? ????? ????? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ???????? ??? ???? ??? ??????? ????? ??????? ??? ?????? ???????.
???? ????? ?????? ????????? ??? ??? ????? ?????? ?? ??????? ??? ????? ????? ?????? ????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ????????? ?? ????? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ????!
?????? ??? ??? ???? ?????? ??? ?????? ????????. ??? ???? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ?????. ????? ?????? ????? ???????.
??????? ???? ????? ????? ????? ???????????? ??? ???? ????? ??????? ???????? ?????. ????? ????? ??????? ?? ???? ????. ???? ?????? ??? ??????? ?? ???????.
????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ???? ????? ???????? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ??? ??????. ?? ???? ???? ??????? ???????? ???? ?????? ??? ????? ???????? ?????! ???? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ?????? ???? ?? ??????.
????? ??? ??? ? ?????? ? ????????. ?? ????? ??? ???? ??????? ????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??????? ????????? ?? ????? ?????.
????? ???? ???? ????? ????? ??? ???????. ??? ???? ???? ????? ???? “?????????” ??? ??? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ???????? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ??????? ? ?? ?????? ?????? ? ????. ?? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ?????? ????? ?????? ???? ???????. ?? ????? ??? ?? ???????? ??? ????? ????? ??????? ???.
?? ?? ?????? ????? ??? ???? ????. ??? ???? ??? ???? ????? ????? ??????? ??? ??? ???? ????? ?? ???????. ??? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ??????. ???? ??? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ???????.
????? ?? ????? ??? ??????. ???????. ???? ?? ?? ?????? ???? ???????? ??????. ??? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????? ????? ??????: “??? ????? ????? ??????. ????? ???? ??????? ???? ??????”.
????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ???????? ?? ??? ????? ?????. ??????? ?? ??? ????? ?????? ?? ????? ?? ???????. ???? ????? ?? ????? ??? ???????? ????? ?? ??? ??????? ?? ???? ????? ??????.
????? ?? ??? ???????? ??? ????? ???????? ????? ??? ????? ????? ??? ?????? ?? ??? ??????? ??????
?? ????? ?? ?????? ? ??? ?? ? ???? ??????? ???????. ?? ?????? ??????? ???? ???? ????? ?? ?????? ? ?? ?? ???? ??????? ?????? ???? ?? ???? ????? ????. ??? ????? ??????? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?????. ????? ???? ???? ??????? ?? ???? ??????.
???? ???????:
?????? ????? ?????? ?????? ???????
??????? ????????
????? ??????? ??????????
??????? ??????? ?????????
??????? ???????? ????? ?? ??????.
??????? ?????. ?????? ??????.
??? ????? ??????? ??? ????????? ?????? ?????????. ??? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????????? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ???????? ???? ?????. ???? ???? ?????? ??????? ?? ????.
???? ?? ?????? ???? ?????? ??? ??? ??? ????. ??? ??? ????? ??? ????? ????? ?????. ??? ??????? ?????? ???? ?????? ?????. ????? ??? ??? ??? ?????? ?????.
????? ?? ?????? ????? ????? ?????.
?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ????? ???? ??????? ?? ????? ???? ?????. ?? ???? ????? ????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ????? ?????.
????? ?? ??? ???? ????????? ??? ???? ??? ??? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ????? ??????? ????? ??????. ?? ????? ??? ???????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????. ????? ??????? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ??????? ?????? ?? ???? ??????.
??? ???? ??? ? ?????? ? ??? ???? ????? ????? ??? ??????? ????? ?? ????: “?? ?? ???? ?????? ?? ?????? ???????? ??????? ???????” ?”???? ???? ????? ?? ???? ???? ?????? ???????? ???????” ??? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ???? ????? ????? ????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ????? ?????. ??? ???? ????? ???? ?????? ??? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ???? ???? ?????? ???? ????? ?????? ????.
??? ??? ???????? ?????? ?????? ?????? “??????” ??? ??????? ???? ????? ??? ???????? ?? ??????? ???????. ??? ???? ??????? ???? ????? ??? ???? ?? ???????? ??????? ?????? ???? ?????.
??? ???? ??????? ????????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ??????? ?????????. ??? ???? ???? ???? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?? ??????? ??? ??? ?????.
??? ????? ????? ???????? ?????? ????? ??? ?????. ??? ????? “????? ??????” ??? ???? ??? ???.
??? ?? ??????.
??? ?????? ?????? ??? ?????.
????? ????.
??? ????? ?? ???????
?????? ???????.
??? ???? ???? ????? ?????? ??? ????? ?????.

(2) ????? ????? ??? ?? ???? (???? ???? ?????)
???? ????? ?????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ??? ??? ???????? ???????? ???? ?? ???? ???? ???? ?????????: “?? ???? ??????? ?? ???? ???????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ????? ?? ????? ??. ???? ?????: ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ?????. ????? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ??? ???? ?? ????? ??????? ????? ??????? ???????? ??????? ????. ??? ????: ???? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ??????”. (7)
???? ?????? ??? ?? ? ???? (1932- 2018) ?????? ????? ??? 1958? ?? ??? ?????? ??????? ?? 1966? ????? ?????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ?????. ??? ??? ?? ? ???? ??? ????? ????? ?? ?????? ???? ??? 2007 ??? ????? ????? ????? ??????? ?? ?????? (?????? ?????? ??????)? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ???? (????????) ?? ???? ??? ????? ????????? ??? ???? ?? ?????? ???? (?????)? ????? ????? ????? ?????? (?????) .
?? ????? ????? (?????? ???? ??????):
- ??? ?? ????
???????? ?????? ????? (??????)?
?????? ?????? ????? ????? ??????.
???? ????? (?????) ?????
?? ???? ???? ???? ??????.
??? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ??????
?????? ?? ????? ????? ?? ??? ?????.
- ????? ?????
???? ?????? ????? ???? ????????
??? ???????? ?????? ??????.
???? ?? ????? ????? ?? ??? “??????”?
??? ??? ?????? ????????? ?????.
???? ???????
??? ?? ???? ????? ????
?????? ?? ????? ????? ?? ????? ??.
(??? “??????” ?????????? ?? “??????” ????? ??? ??? ?????).
- ????? ????
??????? ??????.
???? ???????
???? ?? ??????? ??? ?????
??????? ?? ???????
???? ?????? ??????.
??? ??? ???? ?????? ??????? ??????
??? ???? ?????? ??????? ?????.
- ????
?? ????? ?????????
?? ????? ????????.
????? ????? ??? ????
??? ????? ????? ?????? ?? ????? ??.
???? ?????:
?? ??????? ????? ?????
??? ??? ???? ??? ????? ??? ??????.
????? ??????? ???? ?????? ???????
??? ?????? ???
??? ???? ?? ????? ??????? ????? ??????
???????? ??????? ????.
??? ????:
???? ???? ?? ????? ????? ????? ?????
??? ??? ??????.
- ????????
??????? ??????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ???????
??????? ??????? ??? ????????? ???
??? ??????????? ???? ?????? ??? ????????
?? ????? ???? ???????.
???? ?????? ???????? ??? ????? ??? ?????
?? ?????? ?????? ?????
??? ?????? ?????? ?????
????? ??? ??? ???????
???? ?? ??? ?????
?? ?????? ??????
????? ??? ??????? ?????????.
??? ??? ????? ??? ??????
???? ??? ???? ????? ????? ????????
?? ???? ????? ??? ?????????
???? ??? ????? ??????.
- ??? ?????? ?????
????? ????? ???? ?????? ???????
???? ????? ???????.
????????? ???? ??????? ?????????
??? ???? ??????.
??? ????? ????? ?????
???? ??? ??????.
- ???? ?????
????? ??? ?????? ???????? ??????
?? ??????.
????? ?????? ???? ?????
????? ?????? ?????.
??? ?????? ?? ??? ??????
???? ??????

- ????? ????? ????? ????? (????? ???? ????? ???)
?? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??? (1879 ? 1944)? ???????? ???? ???? ????? (????? “???? ???? ???”)? ?????? ????? ?? ????? ????? ????? ???? ???? ????? ?? ?????? ” ?? ??? ???? ??” ????? ??? “???? ??? ???? ???? ????? ?????.”
???? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ?? ??????? ???????? ????? ?????? ?????? ??? ??? ???? ??? ???? ??????? ??????? ???? ?? ?????? ??????? ???????? “??? ??? ????”?
“????????? ????????? ????? ???????? ??????? ??????????
?????? ??????? ? ???? ????? ?????? ?????.
?????? ??????? ???????? ???? ?????? ?
????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????”.
??? ??????? ????? ??? ?????? ????? ?????? ?????????? ???? ??? ??? ?? ?????? ??? ?????? ????? ???? /?????? (s?n ????????)? ????? ????? ???????? ?? ????? ????? ???????? ??????? ???? ????? ????????? ??????? ?????.
???? ????? ??????? ???? ??????? ???? ?????? ???? ?? ????? ???? ??? ???? ?? ???? ? ??? ???? ????? ?????? “??? ????”? ???? ????? ??? ?????? ?? ??? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???? ?????? ???? ??????.
??? ????? ????? ???????? ??????? ????????. ???? 164 ????? ????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ???? (1909 ? 1939)? ???? “??? ??? ????”.
?? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ?? ??? 1925 ?? ???? ??????? ??????? ?? ???? ????? S?rak ???? ?? ????? ????? ?????? ?? 1905. ?????? ?????? ??????? ???? ????? ????? ?? ????? ??? ??? ???????? ?? ???????.
?? ?????? ???? ????? ??? ??????? ???? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ????? “?????? ?? ??? ???? ??” ????? ?????? ????? ???????? ??????? “???? ?????”? ???? ?? ???? ?????? ????? ??????? ???????? ?????: ????? ??????? ??? ??????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?? ???? ??????.
?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?????? ?? “???” ?????? ??????? ? ???? ?????? ?? ???????? ?????. ?? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ???? / ??? ??? ??? ???? ??? ????? ???????? ???????? (1910 ? 1945).
??? ??????? ??????? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????? ??? ???????? ???????? ?????? ????? ??????? ??????? “??? ?? ??? ???? ??”? ????? ???? ???? ???? ??? ????????? ?????????? ???????:
“???” ??? ??????? ????? ????? ?? ?? ??? ???? ????? ????.
?? ???????? ?? “???” ??????? ??? ????? ???????? ???? ?? “???”.
??? ?????? ?? “???” ??????? ???????? ?? “???” ???????.
“???” ?? ?? ???? ??? ???? ?? ?????”.
????? ????? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ????? / ????? / ??? “???” ?? ??????? ?? ????? ????????? ???????? ??? ?? ???? “???” ?? ???? ???? ??????? ????????? ??????? ????? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ????? ? ????? ????? ????????? ??????? ????????? ???? ?????? ?????????? ????.
???? ????? ?? ????? ?????? ???????? ??? ??????? ????????. ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ???????? ?????? ???? ?????? ????? ??????? ??? ????? ?? “????” ????? ???????? ???? ????? ?????? ????? ?????? ?? ?????.
??? ??????? ????????? ?? ????? ??? ????? ????? ???????? ??? ???? ? ????? ? ?????? ??????? ??????? ???? ????? ????????? ???? ????? 33 ?? ???????? ?????????? ?? ????????.
??? ??? ????? ?? ???? ??????? ??????? ?? ???? ?????? ??? ???? ????? ????? ????????? ????????? ???? ?? ??? ?????? ????? ???????? ????? ?? ??????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?????? ?? ?????. ??? ?????? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ???????? ???????. ??? ????? ??? ?????? ????? “?????” ??? ??????? ??????? ?? ?????? ??? 2014.
?? ????? ?????? ????? “???? ?????”? ???? ?????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ??? (Everything yearned for: Manhae’s poems of love and longing, translated and introduced by Francisca Cho, 2005)? ???? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ???????? ?????? ???????? ????:
??? ??????.
??? ???? ???? ?????.
?????? ????? ????? ??? ???? ????? ????????? ???? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ???.
???????? ??? ?????? ????? ??????? ???? ????? ????? ?????? ????????.
???? ??? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ??? ??????? ?????? ??? ???????.
??????? ??????? ??????? ?????? ????? ???? ???? ?????.
?????? ???? ?????? ? ???? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ???? ??? ????????? ???? ???? ?????? ???????.
????? ??? ??????? ?????? ??? ???? ????? ?????? ????? ???? ????? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ?????.
?????? ??? ??????? ???? ???????? ??? ??????? ???? ?????? ?????.
??? ???? ???? ?? ??????.
?????? ???????? ???? ??? ????? ??? ??? ?????.
??? ?????? “???? ????” ????? ????:
??? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ?????????? (??? ???? ???) ??? ?????? ???????
???? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ???? ????? ???? ??????
?????? ???? ??? ????? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ???????
?? ?????? ???????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ???????? (????? ??????) ????????
?????? ???? ??? ?????? ??????? ?????? ????? ?????? ??? ????? ?????? ?????????
?????? ???? ??? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ???? ???? ????? ??????? ??? ????? ?????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??? ????????
??? ????????? ???? ??????? ????? ??? ????.
?????? ???? ?????? ????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ???? ??????
??? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????? ??? ?? (???????: ????? ?????? ????????)? ??? ???? ????? ????? ??? ????? ????? ?? ????? ??? ????? ???????? ??????? ????. ??? ??? ??? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ??? ????? ????? ?? ??????? ??????? ?? ?????. ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ????? ??????? ?? ?????. ??? ??? ?? ???? ??? ????? ?????? ??????? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ????? ???????? ?? ??????. ??? ??? ??? ????? Simujang. ????? (????) ???? ????? “????? ?? ????” ??? ?? ???? ????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????. ?????? ???? ?? ??? 1933? ????? ???????? ??? ??? ?????.
??? ????? ???? ????? ?????????? ???? ???????? ???????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??????????? ?????????. ???? ????? ???? ???? ??????? ??? ????? (???? ????? ?? ?????). ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? 1944? ??? ??? ?? ????? ?????. ????? ??????
?????? ?? ??? ?? ?????? ???????? ??? ?????????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ????? ?????? ?????? (????? ??????? ???????) ???? ???? ????? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????. ???????? ?? ??? ????? ???????? ??????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??? ???? ??????? ????????? ??????????? ????? ????? ????? ?? ??????? ???????? (????? ????????) ?? (?????? ?????? ??)! (8)
??? ???? ??????? ??? ?? ????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ??????? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ??????? ??? ??? ????? ?????? ??? ???? ? ?? ????.
_______________________
?????
- Mark Davie? Oxford University Press’s, Academic Insights for the Thinking World? Traduttori traditori? https://blog.oup.com/2012/09/traduttore-traditore-translator-traitor-translation/
- ?????????: ????? ?????? ????? / ????? ???? ???????? ? ????? ?????? ???? ????? ? ??? ???: ???? ?????? ??????? ???????? ???? 2012
- ?????? ?????? ?????? ??????? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ??????? ???? ??????? ???????? 2016
- ????? ???? (2011)? ????? ?????? ??????????? 2011-08-26
- ???? ?????? 12 ?????? 2017? ???? ?????????? ?????? ??????? ?? ???? ????:
http://www.alhayat.com/article/891852/????-??????????-??????-??????-??-????-????
- ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ????? ? ????? ???? ??? ????????? ???? 2012
- ?????? ?????? ??? ?? ? ????? ?????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ????????? ????? ????? ????? 2013
- ?????? ?????? ??, The Memory of the Butterflies, Poetry, (Persian), translated by Nasrin Shakibi Mumtaz, Afraz Book, Tehran, 2013
?? ??? ???: ???????? ????? ??????? ????????? ????????
???? ????? ???????? ?????????? ???? (???? ??)? ????? ????????
????? ?????? ???????? ????????? ???? ???? ????????

?????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ???? ????? ?? ????????
??? ??????? / ???? ?????? ????????
?????? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ?????????? ??? ???? ?????? ?? ????? (?????) ????????.
????? ????????: ?????? ??????? ?????? ????!

?????? ??????????? ?????? Andrei Nikolaevich Lankov![]()
???? ???? ???? ??? ???? ????????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ???????? ? ??? ?? ????? ??? ?? ? ????? ????? ?? ??????? ?????????? ??????? ?????? ??????.